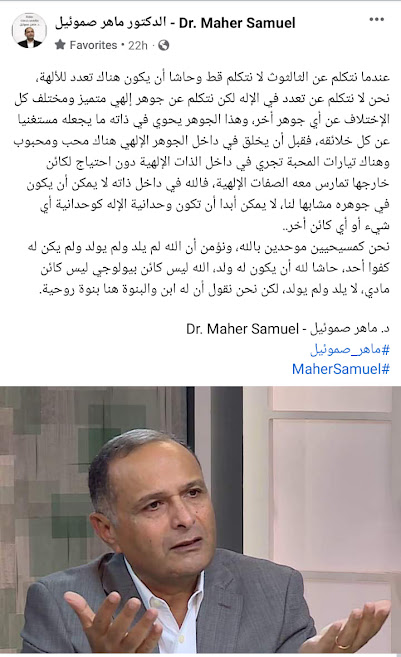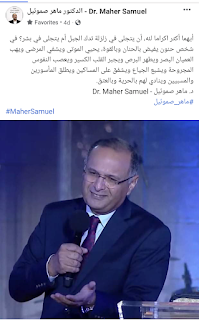الطاعة الإيجابية للمسيح
"إن طاعة المسيح للناموس، وإحتسابها لنا، ليست أقل أهمية لتبريرنا أمام الله، من تحمله لآلام عقوبة الناموس، وإحتسابه لنا، لتحقيق نفس الغاية". (جون أوين) الطاعة الإيجابية تعليم مهمل رغم القيمة الكفارية العُظمى لطاعة المسيح الإيجابية عنا طيلة حياته على الأرض، إلا أنه مع كل أسف فهو تعليم مهمل. ولا سيما لدى البروتستانت الناطقون بالعربية. بالمقابلة مع ذلك، ينسب أصحاب اللاهوت الشرقي تقريبًا كل القيمة الكفارية للتجسد وحياة المسيح على الأرض مع إهمال الصليب لدرجة الطعن في البدلية العقابية. فالكفارة بالنسبة لهم هي اتحاد اللامحدود بالمحدود لكي يشفه (وهذا صحيح ولكن بشرط عدم إنكار باقي جوانب الكفارة من طاعة إيجابية وبدلية عقابية). وبينما يشكل موت الصليب لنا كبروتستانت مركز الكفارة، إلا أننا لسنا في حاجة لإنكار القيمة الكفارية لحياة المسيح للرد على هذا التطرف لللاهوت الشرقي. بل إننا نكون قد أخطأنا خطأً كبيرًا إن أنكرنا تمثيل المسيح لنا في طبيعته وحياته وتقواه. وكما يقول بافينك "لذلك، إنه لأمر متناقض تمامًا مع الكتاب المقدس، أن نحصر عمل المسيح ‘الإسترضائي’ (الكفاري) في آلام...